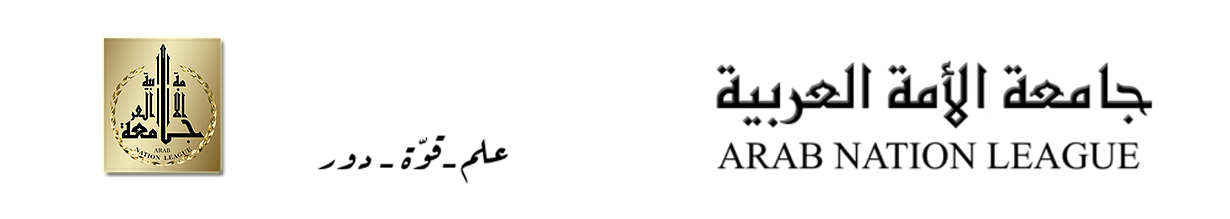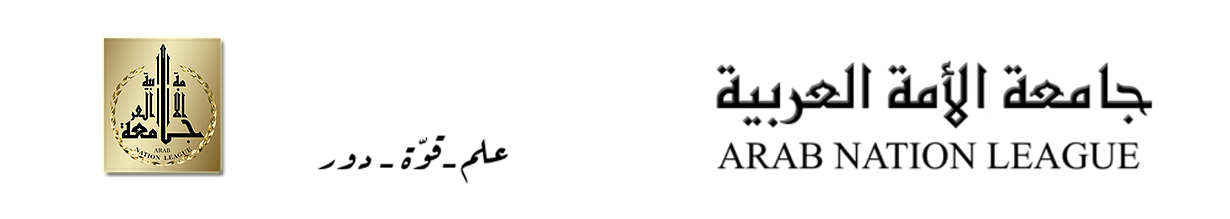من الخَطَأ في الرّأي والتّقدير أن يقال، بقدرٍ من القَطْع المرتَجل، إنّ التّسلُّط السّياسيّ ظاهرة خاصّة بأنظمة الحكم الفرديّ أو حُكمِ القِلاّت (العصبويّة والطّبقيّة والحزبيّة والأوليغارشيّة)، وإنّه كلّما اتّسعت قاعدةُ النّظام السّياسيّ أو اتّسع نطاق الشّركاء فيه (الحلف أو التّكتّل الحاكم) تقلّصت، بالتّبِعة، مساحةُ تسلّطيّته أو اضمحلت وربّما اِمَّحَتْ بالكليّة. وعليه، يُرَدُّ التّسلّط - في هذه الرّواية - إلى الأساس الذي عليه مبْنى
نظام الحكم: الفرد، القلّة، معنى ذلك أنّ النّظام الذي ينشأ على قاعدة حاكميّة الجمهور هو، حكماً، النّظام الأصلح والأوفق والأقلُّ شرّاً وفساداً وتسلّطاً، وهذه عادةً، هي المواصفات التي تُكال إلى النّظام السّياسيّ الدّيمقراطيّ ويُسْعَى إلى إفراده بها من دون سواه من أنظمة حكمٍ أخرى.
والحقُّ أنّه غالباً ما خُصّ هذا النّظام، منذ زمنٍ بعيد، بالتّبجيل من الفلاسفة والمفكّرين والمؤرّخين والسّاسة وسُمِق به إلى أعلى وعُدّ مثالاً للسّياسة المشروعة والصّالحة، غير أنّه ما سبق له أن شهِد على تلميعٍ فائقٍ بلَغ حدود الأَسطرة مثلما شهِد على ذلك في خطاب اللّيبراليّة السّياسيّ: منذ جون لوك، في القرن السّابع عشر، حتّى فرنسيس فوكوياما وأضرابه من منظريّ اللّيبراليّة في بلدان الغرب في الزّمن المعاصر، حتّى أنّه صار في حكم المسلَّمات السّياسيّة السّائدة اليوم القولُ إنّ النّظام هذا بات واحداً من أظْهر المقدَّسات السّياسيّة!
من المعلوم أنّ الفلاسفة اليونان السّقراطيّين انتقدوا نظامَ الجمهور هذا، نقداً شديداً، وكشفوا عن كثيرٍ من عيوبه، حتّى أنّ أفلاطون نَقَمَ عليه وأَنْكَر ما فعله بأستاذه سقراط حين جرّهُ إلى المحاكمة عن أفكاره وحَكَم عليه بالإعدام. إنّه، عند أفلاطون وأرسطو، نظام الفوضى الذي يفتقر إلى العقل - وهو عماد السّياسة - وإلى الفضيلة وهي القيمة الأصلح للدّولة.
لذلك مَالا إلى تفضيل النّظام الأرستقراطيّ، الذي هو نظام حكم الأفاضل، و- خاصّة - نظام الحكم الدّستوريّ الذي أراده أرسطو جامعاً بين فضائل النّظام الأرستقراطيّ والنّظام الدّيمقراطيّ. السّياسة، عند الفيلسوفين، ليست شأناً مشاعاً لكلّ طبقات المجتمع الأثينيّ بحيث يَسُوغ للعامّةِ أن تتدخّل فيه أو تشارك، بل هو شأنُ خاصّةِ المجتمع ممّن تنطبع ذواتُهم بعاقليّة الفعل. لذلك ما أن تُتْرَك السّياسةُ للجمهور حتّى تفقد ميزانَ الرّشد فيها فتميل إلى الغُلوّ وإلى الأهواء وسوء التّقدير.
هذا سبب اعتبار أرسطو النّظامَ الدّيمقراطيّ انحرافاً عن جادّة نظام الحكم الدّستوريّ لأنّه يغلِّب مصلحة القائمين عليه على المصلحة العامّة ويجنح للتّسلُّط سبيلاً إلى تحقيق مصلحة أولئك القائمين عليه، ثمّ لأنّ به تفسُد السّياسة وتتضرّر المدينة وتضعُف قُواها. ولقد ورث الفلاسفة المسلمون (الفارابيّ، ابن سينا، ابن رشد) هذه النّظرة القدحيّة للنّظام الدّيمقراطيّ عن الفلاسفة الإغريق حين عرضوا فلسفتهم السّياسيّة، خاصّة فلسفة أفلاطون في الجمهوريّة أو كتاب أرسطو في الخطابة.
بعد فترةٍ من تظهير نموذجيّة النّظام الدّيمقراطيّ وتعاليه عن سائر أنظمة الحكم الأخرى - وقد ارتبطت بصعود الفلسفة السّياسيّة الحديثة وظهورِ اللّيبراليّة السّياسيّة على ما عداها من الأيديولوجيّات السّياسيّة - شُرِع في نقد هذا النّموذج منذ منتصف القرن التّاسع عشر، مع ماركس، ابتداء، ثمّ - من داخل اللّيبراليّة نفسِها - مع جون ستيوارت مِل. باسم الشّرعيّة الدّيمقراطيّة ومبدأ التّمثيل والاقتراع، احتكرت طبقة اجتماعيّةٌ، تمثِّل أقليّةً في المجتمع، هي الطّبقة البرجوازيّة، السّلطةَ والسّياسة وفرضت سيطرتها على الجميع وحَمَت مصالحها الخاصّة على حساب غالبيّة طبقات الشّعب الكادحة.
وهكذا اتّخذتِ الدّيمقراطيّةَ ستاراً لممارسة التّسلّط. هذه رواية ماركس عن هذا النّظام، وهي لا تختلف، كثيراً، عن رواية جون ستيوارت مِل، الذي ما توقّف عن التّشديد على أنّه باسم السّيادة الشّعبيّة وشرعيّة حكم الغالبيّة المنتَخَبَة، انتهتِ الدّولةُ إلى فرض ما سمّاهُ ب «طغيان الغالبيّة» باسم الدّيمقراطيّة، هذه التي لم ينزّهها ألكسي دوتوكڤيل من تهمة التّسلّط، حيث نَحَتَ مفهوماً جديداً - في وصفه النّظامَ السّياسيّ المنبثق من الثّورة الفرنسيّة - هو مفهوم الاستبداد الدّيمقراطيّ. هكذا عادت مثالب نظام الجمهور إلى حيث وقَع تسليطُ الضّوء عليها من جديد، خاصّةً على مثْلَبَة المضمون التّسلّطيّ في هذا النّظام.
لقد اقترن نظام الجمهور (النّظام الدّيمقراطيّ) بالنّزعة الشّعبويّة في وعي كثيرٍ ممّن تناولوهُ نقديّاً بعيداً عن النّظرات التّبجيليّة والتّقديسيّة. نعم قد تكون الشّعبويّة مناسِبة لنظامٍ قائمٍ على الكاريزما أو على مبدأ الاشتراكيّة، كما في الحالة السّوڤييتيّة الستالينيّة كما درستْها حنّة أرندت، ولكنّها - قطعاً - تطابِق نموذج النّظام الدّيمقراطيّ الذي مَبْناه على فكرة الشّعب صاحب السّيادة ومصدر السّلطة التي يفوِّضها لممثّليه من طريق الاقتراع.
ولقد شهِدت البشريّة المعاصرة على كوارث سياسيّة وجرائم نكراء، لا أوّل لها ولا آخِر، من وراء هذه الشّعبويّة الدّيمقراطيّة، ولقد تكون النّازيّةُ أظْهَرَ تلك الكوارث والجرائم وأشهَرَها في المئة عامٍ الأخيرة: ألم يخرُج النّظام النّازيّ من رحم الدّيمقراطيّة وصناديق الاقتراع؟ وها هي النّظائر النّازيّة الأوروبيّة الجديدة تختمر اليوم وتكتسح مساحاتٍ من التّمثيل مخيفةٍ تقترب، باتّساعها، لحظةُ القيامة السّياسيّة!
بيِّنٌ، إذن، أنّ التسلّط السّياسيّ ظاهرةٌ عابرةٌ لأنظمة الحكم، أيّاً يكن أساسُها: فرداً أو فئةً أو جمهوراً، إذْ هي تعبّر عن اللّحظة المَرَضيّة في السّياسة: لحظة فسادها.