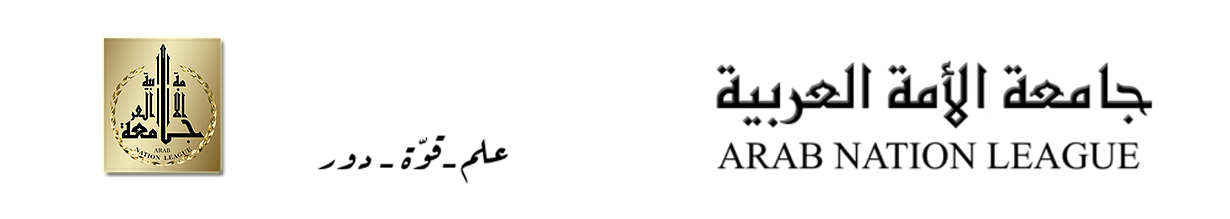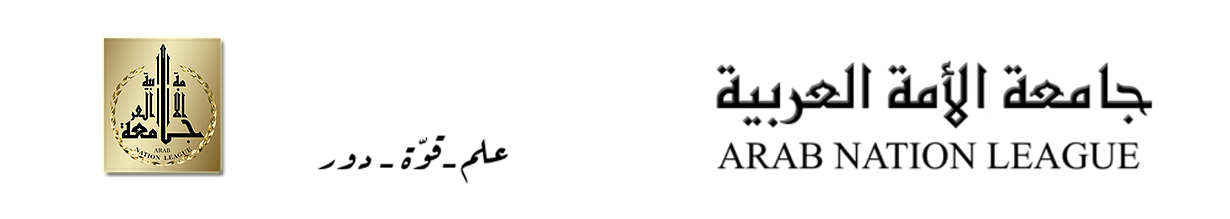الموروث héréditaire، hereditary. يتجلى التراث الثقافي والحضاري للمجتمع بعناصره المتنوعة في سلوك الناس وعاداتهم وتقاليدهم وأنماط تفكيرهم بدرجات متفاوتة، ففي حين يبقى جزء كبير منه حياً في المجتمع، وهو ما يعرف بالموروث، يأخذ جزء آخر بالتلاشي تدريجياً بفعل عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية متنوعة، إلى أن يستقر في ذاكرة المجتمع وتاريخه من دون أن يكون له تأثير فعلي ومباشر في حياة الناس وأشكال تفاعلهم، وفي ذلك تكمن الفروق الجوهرية بين التراث héritage، heritage والموروث.
والموروث وفق هذا التصور هو الجزء الحي من التراث الذي يتجلى في سلوك الناس وعاداتهم وتقاليدهم، في الوقت الذي يمكن أن يعود في جذوره التاريخية إلى مئات السنين، بل آلاف السنين في كثير من الأحيان، ويصعب تلمس بداياته الأولى في تاريخ المجتمع، فاستخدام اللغة يدل على أن أفراد المجتمع يعتمدون في تواصلهم مع بعضهم على موروث ثقافي موغل في القدم، وهو جزء من التراث الذي أنتجته حضارة المجتمع وثقافته عبر تاريخها الطويل، ولكنه يمثل الجزء الحي منه، وما يقال في اللغة يقال أيضاً في التقاليد والعادات وأنماط التفكير والقيم وحتى الأشكال السائدة في تطبيق العقائد الدينية التي تختلف بين المجتمعات باختلاف ثقافاتها، وخصوصياتها التاريخية والحضارية.
أما التراث فيراد به ذلك الكل الذي أنتجه المجتمع عبر تاريخه في مجالات الحياة المتنوعة، الفكرية منها والمادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، أي الموروث التاريخي والاجتماعي والثقافي الذي يعيشه الناس في عاداتهم وتقاليدهم، مضافاً إليه ذلك الجزء الذي تلاشى بتأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فقد تخلت مجتمعات إنسانية عديدة عن أفكار وقيم وأنماط من السلوك وتقاليد كانت في يوم من الأيام ذات تأثير قوي في حياة الناس، لكنها تلاشت بفعل عوامل التغير، على الرغم من أنها مازالت حية في ذاكرة المجتمع وتاريخه وماضيه.
وبالقدر الذي يميز فيه الباحثون بين التراث الثقافي والاجتماعي والسياسي للمجتمع كذلك يميزون بين الموروث الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ذلك أن الواقع المعيش هو دائماً نتاج لتفاعل الماضي مع الحاضر، أي تفاعل الموروث الثقافي والسياسي والاقتصادي للمجتمع مع المستجدات الحديثة التي تطرأ عليه وتؤثر فيه، وليس من اليسير أن يكون المجتمع قادراً على التحرر من ذلك الموروث الذي يؤلف جزءاً أساسياً من حاضره، بل الجزء الأكبر منه، لما له من سطوة على أنماط التفكير، وطرق العيش، وأساليب الحياة التي تؤثر على نحو مباشر في أشكال تفاعله مع المستجدات الحديثة، وفي أشكال استجابته لها، الأمر الذي يجعلها جزءاً منه.
وفي الوقت الذي يأخذ فيه بعض الباحثين - وخاصة أتباع نظريات التطور- بدراسة التراث على أنه نتاج لمرحلة تاريخية سابقة، ويستمد أهميته من الدور الذي كان يؤديه بالنسبة إلى المجتمع في تلك المراحل؛ يجد باحثون آخرون أن أهميته تأتي من الوظيفة التي يؤديها في بنية المجتمع، والتي يمكن أن تتناقص مع مسارات التغير المجتمعي.
ففي سياق تحليل المادية التاريخية le matérialisme historique، تأخذ العادات والتقاليد وأنماط التفكير والعلاقات الاجتماعية أشكالها في سياق الشروط التي تنظم عمليات الإنتاج في كل مرحلة تاريخية من مراحل التطور، وتعدّ هذه الشروط الأساس الراسخ الذي يقوم عليه البناء القانوني والسياسي، فيؤثر شكل الإنتاج في مجمل العمليات الاجتماعية والسياسية والروحية، ويخلص ماركس[ر] K.Marx إلى القول: إن الوجود الاجتماعي هو الذي يحدد أشكال الوعي وليس العكس، غير أن تطور المجتمع إلى المراحل الأكثر تطوراً يجعل البناء الفوقي المتوافق مع مراحل تاريخية سابقة مهدداً بالانهيار، إلا أن قوته في وعي الناس ورسوخه التاريخي يجعل منه واحداً من العوامل التي تعوق التطور، ومع ذلك فإن تطور قوى الإنتاج في المجتمع قادر على أن يحطم البناء الفوقي التقليدي، ويؤسس لبناء فوقي جديد تنسجم مكوناته مع شروط التطور الجديد وخصائصه، ومن ثمّ فإن تلاشي جزء من التراث الاجتماعي والثقافي والحضاري لمجتمع ما عبر مراحل التطور المتلاحقة إنما يعكس مستوى التطور الذي يشهده هذا المجتمع، فالتقاليد والقيم والعادات ومنظومات التفكير التي كانت سائدة في مرحلة المجتمع العبودي تأخذ بالتلاشي مع الانتقال إلى مرحلة المجتمع الإقطاعي، ويزداد تلاشيها في مرحلة المجتمع الرأسمالي. وفي كل مرحلة تظهر منظومات اجتماعية تحدد أشكال التفاعل التي تنسجم مع مراحل التطور الجديدة، في حين تختفي فيه المنظومات القديمة، تبعاً لدرجات التطور.
وعلى طرف آخر تأخذ مدارس التحليل الوظيفي functionnalisme بدراسة التراث في ضوء الوظائف الاجتماعية التي يؤديها بالنسبة إلى الأفراد، والجماعات والأسر، وبالنسبة إلى المجتمع بصورة عامة، فالتراث الحي في حياة الناس من ظواهر اجتماعية وعادات وتقاليد وأنماط التفكير لا يستمد مشروعيته من المراحل التاريخية التي نشأ فيها بقدر ما يستمد أهميته من الوظائف التي يؤديها في حياة الناس، فما من ظاهرة أو عادة أو نمط سلوكي إلا ولها وظيفة اجتماعية تسوغ انتشارها، بصرف النظر عن تاريخ نشوئها، أما الظواهر والعادات والتقاليد وأنماط التفكير وكل ما يمكن إدراجه في قائمة التراث فإنها تأخذ بالتلاشي عندما تفقد وظيفتها الاجتماعية، وتفقد الدور الذي يمكن أن تؤديه في الاستقرار الاجتماعي، وفي عملية التكيف مع البيئة والمحيط.
وفي الوقت الراهن يُلاحظ أن قضايا التراث والموروث في المجتمع العربي تستحوذ على اهتمامات الباحثين والمفكرين العرب على نطاق واسع، فبعضهم - وخاصة أصحاب مشروعات التطوير والنهضة - يجد أن الموروث الثقافي العربي يشكل عقبة أمام تطوره الاقتصادي الاجتماعي، فتحول مجموعة العادات والتقاليد والقيم دون تفاعل الناس مع المستجدات الحديثة على نحو إيجابي، فيتخذون من كل جديد مواقف عدائية؛ لما للموروث من حضور قوي وسطوة نافذة تظهر في أنماط تفكيرهم وطرق عيشهم.
وقد شهد عصر النهضة أعداداً كبيرة من المفكرين الداعين إلى ضرورة التحرر مما علق بالتراث العربي الإسلامي من شوائب تعوق الرؤية الحقيقية، وتحول دون تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع. فهاهو قاسم أمين يركز على الدعوة إلى تحرر المرأة، فقد أدى التمسك بالموروث الاجتماعي إلى نشوء مظاهر عديدة لظلم المرأة وامتهاناً لحقوقها، فقد استنكر بشدة قول القائلين: إنّ النساء ربات الخدور وإن وظيفتهن تنتهي عند عتبة البيت، كما استنكر الرأي القائل: إن تعليم المرأة وعفتها لا يجتمعان، وأكّد وجوب التلازم بين تحرير المرأة وتحرر المجتمع، ذلك أن تمتع النساء بحريتهن الشخصية يقود إلى تمتع الرجال بحريتهم السياسية أيضاً، فالحالتان مرتبطتان كلياً، أما ما علق في وعي الناس من دونية المرأة وسيطرة الرجل فما هي إلا أشكال من الموروث الذي يعوق التطور الاجتماعي ويحول دون تطور المجتمع في الوقت الراهن، ويمضي في التوجه ذاته عدد من مفكري عصر التنوير في نهايات القرن التاسع وبدايات القرن العشرين، وقد وجدوا أن جزءاً كبيراً من العادات والتقاليد والأفكار المتوارثة يحول دون تحقيق تطوير اجتماعي واسع.
وفي الوقت الراهن، تبدو الصورة ذاتها ولكن بأشكال مختلفة، فالموروث الثقافي والاجتماعي الذي يتجلى في عادات الناس وتقاليدهم وأنماط تفكيرهم ما زال موضع اهتمام عدد كبير من المفكرين العرب المعاصرين، لما له من تأثير في طرق تعامل الناس مع الواقع، وعدم قدرتهم على الخروج من خصائصه وأبعاده.
في هذا السياق يجد محمد عابد الجابري أن القارئ العربي مازال مؤطراً بتراثه الذي يحويه، وأنه يفقده استقلاله وحريته، فهو يتلقى تراثه منذ ميلاده كلمات ومفاهيم، لغة وتفكيراً، وطريقة في التعامل مع الأشياء. كل ذلك من دون نقد؛ ومن دون روية؛ وبعيداً عن الروح النقدية، فهو عندما يفكر يفعل ذلك بوساطة التراث، ومن خلاله، ويستمد منه رؤاه واستشرافاته مما يجعل التفكير عملية تذكر، وعندما يقرأ نصاً من تراثه يقرأه متذكراً لا مكتشفاً ولا مستفهماً.
والقارئ العربي - كما يرى الجابري أيضاً - يطلب السند من تراثه، ويقرأ فيه آماله ورغباته، ويريد أن يجد فيه العلم والعقلانية والتقدم، أي كل ما يفتقده في حاضره على صعيد الحلم وعلى صعيد الواقع، ولهذا فهو يسابق الكلمات، عندما يقرأ النص، بحثاً عن المعنى الذي يستجيب لحاجاته، يقرأ شيئاً ويهمل أشياء، فيمزق وحدة النص ويحرف دلالته ويخرج به عن مجاله المعرفي التاريخي، وهو يريد مواكبة العصر؛ لكن العصر يهرب منه.
أما حسن حنفي فيمضي بخطى أكبر في نقده للفهم السائد للتراث الذي يعدّ واحداً من العوامل الأساسية التي تعوق مسارات التطور في المجتمع العربي الراهن وفق تصوره، فهو يرفض بقوة المقدمات التقليدية في علم أصول الدين الإسلامي، لأنها مقدمات تعبر عن إيمان ذاتي خالص، وتصدر عن الغيب، في حين لا تأتي المعرفة الصحيحة بتصوره من علو، ولا تُنال هبة مسبقة من السماء، كالوحي والإلهام وإنما تأتي من التأمل في المعطيات الفكرية والواقعية، وتتم عن طريق التحليل العقلي الرصين للأفكار والوقائع، وباستقراء مجرى الحوادث، وهو يعلن صراحة خروجه عن التقليد المتعارف عليه في الثقافة الإسلامية، وعدم انتهاجه خطى السلف الصالح، على مبدأ أنهم رجال ونحن رجال، نتعلم منهم من دون أن نقتدي بهم بالضرورة، وهو يدعو إلى نقل محور الاهتمام من الله والرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإنسان حيث ينبغي أن ينصبّ الجهد ويتركز البحث، ويمضي في الطريق ذاته عدد آخر من المفكرين العرب المعاصرين.
وعلى طرف آخر، مازال عدد آخر من المفكرين العرب يرى عقم محاولات فصل التراث عن الحاضر في مشروع النهضة، ذلك أن المجتمع كل متكامل وليس من اليسير فصل الروحي منه عن المادي، وإذا كان هناك ثمة أخطاء في الفهم والتطبيق فإن الأمر لا يسوغ مشروع الفصل بين التراث والواقع، إنما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في كثير من معطيات التراث، ولكن ليس في ضوء الثقافة الغربية، إنما في ضوء التراث العربي الإسلامي ذاته، فدراسة التراث العربي وصلته بالواقع المعيش من منظور الفلسفات الغربية إن هو من حيث النتيجة إلا شكل من أشكال فصل التراث عن المعاصرة، ومن ثمّ إفقار المجتمع من هويته الثقافية والحضارية.
إن التفاعل البناء مع مستجدات العصر يتطلب تأكيد الهوية الثقافية والاجتماعية التي تميز المجتمع العربي من غيره من المجتمعات الإنسانية، وفيها تمتزج عناصر التراث الحي مع الواقع وتتفاعل معه ليستمد منها قوته، فتزيده صلابة وقوة، في الوقت الذي يغنيها بتجاربه الجديدة، ويعمق من قوتها وأصالتها.
والثقافة العربية الإسلامية، وفق هذا التصور، على حد تعبير أبي زيد العجمي، تتصف بجملة من الملامح الأساسية، التي يتفاعل فيها التراث مع الواقع، والتي تجعلها ذات خصوصيات تميزها من غيرها من الثقافات، ومن هذه الملامح أنها ثقافة دينية الأصل والمرجع أولاً، وهي ثقافة تعلي من شأن الإنسان ثانياً، وتقوم على الحوار مع الآخر ثالثاً، ومن شأن هذه الخصائص أن تساعد على فهم الواقع برؤية إسلامية وتسهم في تحقيق التفاعل الإيجابي مع تطوراته بروح العصر، مع ضرورة تأكيد أهمية تجديد الفكر الديني وتنقية التراث والاستفادة من منجزاته البناءة، وإهمال مالا فائدة منه، وما يمكن أن يكون مصدر خطر على المجتمع.
والتجديد وفق هذا التصور لا يعني تجديد الدين في مصادره وإنما يراد تجديد فهم الدين بمعطياته التي تحدد علاقة الفرد بالخالق وعلاقته بالإنسان وعلاقته بالكون، ومن شأن تجديد فهم الدين أن يضع الأشياء في مكانها الصحيح، ووفق هذا التصور تعدّ الثقافة الدينية عنصراً أساسياً من عناصر الثقافة العربية المعاصرة التي تمكّن المجتمع العربي من التفاعل الحقيقي مع مستجدات العصر وتحدياته.
ومن الملاحظ أن الرؤية التفاعلية للعلاقة بين التراث والحاضر مازالت تنتشر بدرجة كبيرة بين المفكرين والمثقفين، سواء بين الذين يجدون أن الموروث من التراث يعوق عملية التطور لما يحمله من خصائص متناقضة لا تتوافق مع شروط التطور الاجتماعي، أو بين أولئك الذين يجدون أن التراث هو قوة دفع إيجابية نحو التطور لما يتصف به من مصداقية تفوق ما يرد المجتمع من ثقافات جديدة لا تتوافق وخصوصياته التاريخية، الأمر الذي يجعله صالحاً للتطورات المختلفة.
أثبتت الرؤية العلمية أن دور التراث والموروث منه في بناء المجتمع لا يكمن في طبيعته بذاتها، إنما في أشكال تجلياته في المجتمع، وفي الوسط الاجتماعي، فالتمييز الذي يشيده الباحثون بين الماضي والحاضر في بنية الثقافة هو تمييز تحليلي، وليس من اليسير تلمسه في الواقع الفعلي، لأن المجتمع في كل لحظة تاريخية هو نتاج كلي لماضيه وتاريخه، وقد يؤدي عزل المجتمع عن ماضيه، إلى فقدانه خصوصياته التي تميزه من سائر المجتمعات، كما أن دمج الواقع مع الماضي يؤدي أيضاً إلى إغفال مكونات أساسية ومهمة في بنية المجتمع تشكلت بفعل تواصله الثقافي مع المجتمعات الأخرى، وما هذا الإغفال إلا شكل من أشكال الفصل القسري للمجتمع عن حاضره، الأمر الذي يؤدي إلى تغييب الهوية الثقافية والخصوصيات التاريخية بالمقدار نفسه الذي أدى إليه عزل المجتمع عن ماضيه.