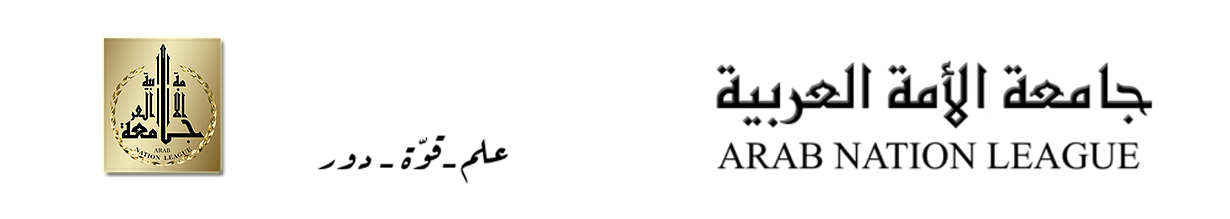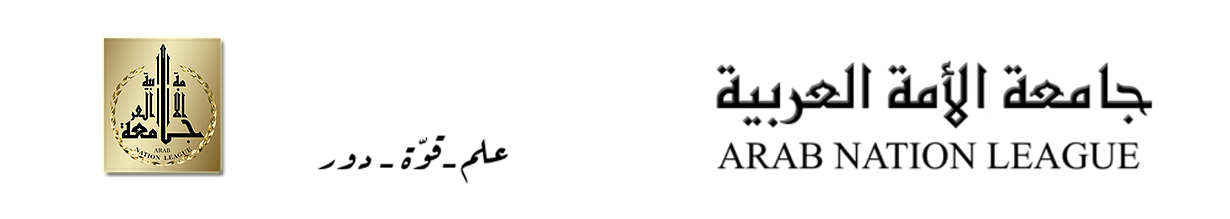إن انطلاق الأعمال العسكرية الروسية في 24 شباط 2022 ربما سيكون الحدث الأهم على صعيد الجيوبوليتيك الدولي، خلال القرن الواحد والعشرين، لما قد يعنيه من تحولات كبرى في شكل النظام الدولي، وربما في نوعيته وآلياته أيضا. كما أنه يمكن النظر إليه بصورته الأعمق والأوسع، كتعبير عما هو أكبر بكثير بما لا يقاس بزمن المعارك الدائرة كأسابيع أو أشهر، يبدو أنها ستطول، ويبدو أننا بحاجة ماسة لسبر أغوارها، ومحاولة الإضاءة على جوانب كثيرة منها.
في نهاية الحرب العالمية الثانية، بدا الاتحاد السوفييتي “عدوا” بالنسبة للغرب وبصورة مستغربة وغير قابلة للفهم، فكيف يطلق الرئيس الأميركي (هاري ترومان) “مبدأ ترومان” الهادف “لمواجهة الشيوعية في كل مكان” مباشرة عقب نهاية الحرب، التي كانت فيها تلك الشيوعية هي الشريك الرئيس والأكثر فاعلية في هزيمة ألمانيا النازية، التي شكلت خطرا وجوديا على مجمل المنظومة الغربية وقتها.!! تم إنشاء حلف الناتو في الرابع من نيسان 1949 كمعاهدة “دفاعية” قامت بناء على ترصد “اعتداء خارجي” على الدول الأعضاء فيها وهي متمحورة حول أميركا وبريطانيا وفرنسا بشكل أساس. كان واضحا أن الحلف تشكل في سياق المواجهة مع الشرق، وتحديدا الاتحاد السوفييتي، والذي بادر إلى الرد بتشكيل حلف وارسو في أيار 1955 وما عرف بالكتلة الشرقية آنذاك، في محاولة لوضع ترتيبات مقابلة لاستنفار المعسكر الغربي ضد الشرق، وتحديدا عقب انضمام ألمانيا للناتو في 1954.
إذا فإن محاولة توسيع الناتو وحدها كانت كفيلة بتشكل حلف مواجه له. ولكن ما حدث بعد ذلك بعقود من النزاع الدولي المستمر، والذي سمي بالحرب “الباردة” برغم الحروب التي حدثت خلاله، بهدف استنزاف كل من الحلفين للحلف الآخر، وكانت نتيجتها “الحاسمة” في نهاية ثمانينات القرن الماضي، انهيار الاتحاد السوفييتي كدولة موحدة، وانفراط عقد حلف وارسو وزواله. كان الأمر اللافت وقتها، استمرار التحشيد الغربي تحت مظلة الناتو والسعي لتوسعته، فبين عامي 1991 و 2020 تم دعوة وتنظيم قبول كل من المجر والتشيك وبولندا (وهي دول من حلف وارسو)1997، ثم تلا ذلك ضم سبع دول من أوروبا الشرقية بين عامي 1999 و 2000 ثم سبع دول جديدة في 2004 واستمر مسلسل التوسع حيث انضمت كل من ألبانيا وكرواتيا في 2009، والجبل الأسود 2017 ومقدونيا الشمالية في 2020 . إذا فحتى الأمس القريب جدا كان مسلسل توسع الناتو مستمرا، برغم زوال “الخطر الشرقي” الذي كان يفترض أنه هو السبب “الدفاعي” للناتو.
لا يبدو مبررا بصورة كافية هذا السعي المستمر في التمدد من قبل الناتو باتجاه الشرق، إلا في سياق إصرار المعسكر الغربي على المواجهة، والتي لا تخلو منها أدبيات المحللين والمفكرين الغربيين من رواد السياسة الجغرافية، أمثال (ماكيندر) و(سبيكمان) و(هنتغتون) و(فوكوياما) و(غريغل).. الخ وهم جميعهم يعتبرون أن “الأرض المركزية” التي تشكل روسيا والصين معظمها، كامتداد لتلاقٍ أوروأسيوي، “المنطقة الحاكمة والمسيطرة على العالم، أو المرشحة للقيام بذلك”، في ظل الإمكانات القارية الهائلة التي تمتلكها، كالموقع والموارد الطبيعية الأكبر على مستوى العالم. ثم لنجد المرتكز المشترك بين مختلف اجتهاداتهم في العلوم السياسية والجيوبوليتيك، هو “ضرورة السيطرة على تلك الأرض المركزية، أو محاصرتها على أقل تقدير من أجل ضمان الحاكمية على العالم”.
إن أهم ما تملكه “الأرض المركزية” من العالم اليوم، هو الوحدة السياسية. فتلك الجغرافيا العظيمة، وكل الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة المتوفرة فيها، تخضع لسيادة دولتين اثنتين فقط، خلافا لمجمل خريطة العالم، والتي تم النجاح في تفتيتها وتمزيقها لقطع صغيرة، تفرقها النزاعات، وتجمعها التبعية. لهذا بالضبط يمكاننا فهم سبب تكرار التصريحات الروسية التي تتحدث عن “رغبة الغرب في تقسيم روسيا”، فذلك يبدو بالفعل التحدي الأكبر الذي يواجه السيادة الغربية على العالم، والتي استمرت لقرنين على الأقل، وهي تترنح اليوم على وقع التآكل وانتهاء البلاء الجيوسياسي، كما أنها (السيادة الغربية) تقف اليوم بشكل لم يسبق له مثيل من الازدواجية التكتيكية، فهي تمارس تقية لافتة في التصرف إزاء روسيا، حيث تصرخ الدول بشيء وتقوم بعكسه، وتحديدا على ضفتي الإعلام والديبلوماسية، والتعاطي الحقيقي خلف الكواليس بالإقتصاد مع ملف “العقوبات” ومسألة الطاقة والقمح، ومع اتخاذ روسيا قرارا استراتيجيا لإدخال الروبل كعملة عالمية، وبصورة ناجزة من الواضح أنها ليست للمناكفة، ولكن لتثبيت قواعد دولية جديدة.
دخول دول كبرى كالصين والهند وإيران، في سياق هذه المنظومة، وحتى دول محسوبة تاريخيا ضمن المعسكر الأميركي كالسعودية، وتطوير أنظمة رقابة وتعامل بنكية خارجة عن سيطرة المؤسسات المحتكرة لذلك، لم يأتي إلا كعمل ممنهج لاستكمال جهود كبيرة كانت قد قامت بها منظومتي بريكس وشنغهاي، لتكريس واقع مالي واستثماري عالمي جديد. إن تأسيس بنك للتنمية لمنظمة شنعهاي برأس مال يفوق رأسمال البنك الدولي، مع رفض انضمام الولايات المتحدة حتى بصفة مراقب، كان مؤشرا واضحا قبل سنوات.
إذا فالمسألة وكما يبدو من تتبع الأحداث والتطورات الطويلة، لم تبدأ في الأمس القريب، ولكنها ومن سلوك كلا المعسكرين تبدو واضحة وراسخة في النظام الدولي الذي نعرفه حتى الآن، ولم تبرح ممراته منذ عقود. من هذه الإطلالة على المشهد والتغيرات المستمرة الموجهة فيه بإحكام نحو التملص من السيطرة الغربية بالنسبة للشرق، ومحاولة كبح ذلك التملص، والإصرار على الحفاظ على الدور بالنسبة للغرب، ومهما كان الثمن كما يبدو، فلقد شن عدد كبير جدا من الحروب في هذا السبيل، من فييتنام إلى أفغانستان، وصولا إلى العراق وغيرها، في موجات تجلت في العقدين الماضيين بمشاريع الفوضى والقلاقل التي اجتاحت دول الهلال المحيط بتلك الأرض المركزية، وحاولت جاهدة الوصول إلى قلبها أيضا، تحت شعارات “الثورات الملونة” و”الربيع العربي” التي شكلت التجسيد العملي والمعلن لمشروع “الفوضى الخلاقة” الذي بدأ التخطيط له في بداية الثمانينات من القرن العشرين عند استلام “المحافظين الجدد” للحكم في الولايات المتحدة، ضمن إدارة ريغان.
فتلك القلاقل والانتفاضات المدعومة من الغرب اندلعت أو حاولت ذلك، في الصين وإيران وروسيا وجورجيا وأوكرانيا وقيرغيزيا والعراق وسوريا ولبنان، وشكلت كل واحدة منها تحد ما للدول الشرقية وتحديدا الصين وروسيا، ويبدو أن الاستعداد لمواجهتها خضع لعدة اعتبارات موضوعية، منها الأهمية الجيوسياسية للبلد أو المنطقة المستهدفة، وأيضا قوة المنظومة السياسية في ذلك البلد وقدرتها على الاحتواء والنجاة، ومستوى التنسيق بين دول المعسكر الشرقي غير المعلن.
تلك المعايير أعلاه، تمكننا من فهم عدم المبادرة، أو القدرة على حماية دول مثل العراق وليبيا مثلا، بينما شكلت دولا أخرى مثل سوريا وأوكرانيا واليمن خطوطا حمراء لم يعد بالإمكان بعدها السكوت و”المهادنة” بانتظار غدٍ سيحمل بوادر المزيد من القوة العسكرية والاقتصادية لدول الشرق، والتي ستمكنها من التصدي بفاعلية أكبر للمحاولات الجادة من الغرب باتجاه إعادة إضعافها، وربما تدميرها إن أمكن.
في أوكرانيا تمت الإطاحة أكثر من مرة باستخداد “الشارع” المدعوم من الغرب، بالحكومة المنضوية في إطار المنظومة السياسية الشرقية، وتحديدا نحن المظلة الروسية، انسجاما مع حقائق التاريخ والجغرافيا، التي تخبرنا بأن روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء، كلها دول تنتمي لنفس النسق في النشأة العرقية والحضارية، لا بل إنه من اللافت أن أوكرانيا الحالية تحكم هي الأرض الأقدم لِتَشَكُّل هذه الكيانات السياسية الحضارية. المهم أنه وعقب الإطاحة الأخيرة بنظام الحكم المنتخب في كييف سنة 2014 بدأت الأعمال العسكرية المباشرة، وأيضا أعمال التنكيل بالمواطنين الأوكرانيين الناطقين بالروسية، أو ذوو الميول السياسية الشرقية، بصفتهم “أعداء للقومية الأوكرانية”. طبعا ذلك لم يكن مفاجئا لأحد ضمن مجتمعات الدول المعنية، وفي أروقتها السياسية، فما صدر عن القوميين الأوكران، كان فقط استكمالا لتاريخ من القومية العنصرية في الإقليم، فالتاريخ يخبرنا بأن أسلافا قريبون جدا لهؤلاء وخلال الحرب العالمية الثانية قاموا بالانضمام للقتال في صفوف الجيش الألماني ذي العقيدة النازية وقتها، عند قيامه بغزو الاتحاد السوفيتي صيف 1941. كانت إعادة منح (استيبان بانديرا- 1909/1959) زعيم الحركة القومية الأوكرانية وقائد الوحدات القومية المقاتلة مع النازيين ضد الاتحاد السوفييتي، لقب “بطل أوكرانيا” في 2014 مترافقا مع مظاهرات ومطالبات قوية من القوميين الأوكران، مؤشرا واضحا على مدى وجود تلك النزعات العنصرية، وعلى عمقها خلال العقود السابقة. ولكن الأهم برأيي كان إغفال الغرب لكل ذلك، إذا لم نقل مباركته، من أجل استخدام هذه الكتلة العنصرية، في مواجهة الشرق أو روسيا مجددا. لقد وصل عدد ضحايا عمليات القتل والتنكيل والقصف العسكري لمناطق شرق أوكرانيا لبضعة آلاف خلال السنوات الثمان التي تلت الإطاحة بالحكومة في 2014 وصولا لبدء العملية العسكرية الروسية الأخيرة. الأمر الذي لا يمكن إغفاله هنا هو إخفاق الإعلام الروسي والشرقي عموما في تسليط الضوء على كل ذلك بوقته، فحجم ونوع الممارسات كان سيكفي لو استخدم بشكل منهجي ووطني في الإعلام، لتشكيل رأي عام في روسيا والدول الحليفة لها، وربما في بقية دول العالم، ليس لتفهم العملية العسكرية، ولكن حتى للمطالبة بها. فمشاهد قصف المدن وإرسال الجيش للتصدي للمظاهرات شرقي أوكرانيا، في مفارقة قل نظيرها حيث كانت تلك المظاهرات متزامنة مع مظاهرات تحدث في كييف، ولكنها تخالفها في الرأي والتوجه. كما كانت مشاهد حرق الناس ورميهم من أسطح وشرفات الأبنية، أو سحلهم، كلها تدعو العالم للوقوف بحزم ضد كل ذلك، تماما كما أنها تبلور قناعة لدى الكثيرين بأن هذه الحرب بدأت بالفعل في 2014 وليس في مطلع عام 2022.
هنا يمكننا الدخول إلى التكتيك الروسي الذي بدأ ومع مرور الأيام في للعملية، يكشف عن عمق أكبر في التاريخ القريب، حتى صار يحثنا على تسميته بالتحضير الاستراتيجي للعملية، خلافا لما بدى قبلها أو إبان بدايتها. فاليوم ننظر إلى السلوك الاقتصادي والديبلوماسي الروسي وخلال سنوات وليس أسابيع وأشهر، بصورة تدفعنا للاعتقاد بأنه كان موجها للوصول ليوم 24 شباط وما سيليه، حيث القوة الكامنة غير مفهومة ويصعب تقديرها، خاصة وأنها متغلغلة في عمق الاقتصاد والسياسة الغربيين، وآثارها تدل عليها.
بداية تمكنت روسيا من خداع العالم مرتين فيما يخص بدء العملية ومداها، مرة عندما أقنعت الأغلبية بأنها “لن تقدم عليها”، ومرة أخرى أهم عندما أوهمت الجميع بما فيهم أشد مؤيديها بأن العملية ستكون “محددة وسريعة”، ثم أثبتت الأيام عكس هذي وتلك. أما بالنظر للسلوك الغربي تجاه العملية، يبرز غياب استخدام اسم “الاتحاد الأوروبي” بشكل شبه كامل منذ بدء العملية العسكرية، فصارت نشرات الأخبار تتحدث عن هذه الدولة وتلك، في مؤشر واضح على انفراط عقد “السياسة الجماعية” لدول أوروبا. ثم بدأت التناقضات تطفوا على السطح أكثر وأكثر، وما يميزها ذلك السلوك المرتبك والمتضارب بين ما يعلنه وبين ما يفعله في الحقيقة. فالدول تعلن العداء تجاه روسيا، وتدعو لوقف استيراد الطاقة، و”تفرض العقوبات”، فيما تذهب فرادى للاستمرار بالعلاقات الاقتصادية، وحتى التنسيق السياسي مع روسيا. فنحن نجد ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي وقاطرة تلك المنظومة تعلن أنها ستقبل الدفع بالروبل، ويحرص مستشارها تماما كما يحرص الرئيس الفرنسي على استمرار التواصل والتنسيق مع الرئيس الروسي، برغم فتح باب التحريض الإعلامي ضد روسيا، فهم يقولون شيئا ويفعلون عكسه كل يوم.
في المقابل وعلى ضفة الداخل الروسي، وبين الحلفاء، نجد أن الجبهة تبدو آخذة بالمزيد من التماسك والانسجام. قام مركز (ليفادا) الروسي لاستطلاع الرأي، وهو مركز معارض ومدعوم من الغرب، بنشر نتائج استطلاع أجراه أواسط نيسان، بين فيها وعلى مضض أن نسبة تأييد العملية العسكرية ترتفع إلى 81% ، وأن شعبية الرئيس الروسي ارتفعت هي أيضا من 59% في مطلع الحرب، إلى 85%. الروبل الروسي يحصد نتائج إيجابية لما يوحي بأنه إعداد جيد للأسلحة الاقتصادية، وللقرارات التي رافقت العقوبات على المستويين الداخلي والخارجي. وروسيا تقبض ثمن الحرب تحديدا من دول الغرب، عبر الفائض الكبيرفي أسعار الطاقة المستمرة في التدفق إلى دول أوروبا بينما يستمر تدفق ثمنها وبالروبل هذه المرة إلى الخزينة الروسية. وفي هذه الأثناء تقيم روسيا عدة اتفاقات اقتصادية ومالية مع دول كبرى وحليفة كالصين والهند وإيران، وحتى السعودية، تضمن استبدال أنظمة التحويل والرقابة على المصارف واستخدام العملات المحلية. وتبادر روسيا لبيع المشتقات النفطية لحلفائها بأسعار تفضيلية، وعلى سبيل المثال فقد تم توقيع اتفاق في شباط2022 بين روسيا والصين لتوريد 10 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى الصين خلال العقود القادمة، وتأتي الاتفاقات العسكرية والتنسيق السياسي ليكلل كل ذلك، أو ليثبته. (في 5.5.2022 صرح السفير الصيني في موسكو أن الصين “ستواصل التعاون العسكري التقني مع روسيا على أوسع نطاق، لضمان التوازن الاستراتيجي”).
نعم إن ما يحدث يتخذ شكل التغير الاستراتيجي في شكل وبنية النظام الدولي الذي نعرفه، بفضل تلك المسؤولية التاريخية الكبيرة التي حملتها القيادة الروسية في مواجهة التمدد الغربي الحاصل بصورة مستمرة منذ عقود، والذي أثبت أنه غير قابل للاكتفاء من تلقاء ذاته. حيث كان يمكن للساسة الروس أن يتصرفوا بتساهل مستلهمين تجربة يلتسن وكورباتشوف في “السلام مع الغرب”، تاركين السفينة تغرق رويدا رويدا، على أنغام “العولمة” و”القرية الكونية”، دون تحمل أي مسؤولية عن مصير روسيا والعالم، لندخل في قرن جديد من التبعية للغرب.
على المستوى التكتيكي تقوم المواجهة الحالية بما يلي:
– إضعاف الاقتصاديات الغربية، واستنزاف فوائض الثروة فيها، على صعيد احتياطياتها من الطاقة والثروة، فهي تجد نفسها مضطرة لهدر إمكاناتها إما في لعبة المكابرة في الاستجابة للتدابير الروسية بشراء الطاقة وفق القواعد الجديدة، أو على الأقل دفع أسعار أغلى لتلك الطاقة، بسبب سياسات الترهيب والعقوبات التي أعلنتها على روسيا، وحمى التضخم التي أنتجها ذلك.
– تثبيت القواعد الجديدة في التعامل وتوزع القوى والأدوار في النظام الدولي، بما فيها ما يمكن وما لا يمكن، فلقد تغيرت الكثير من الأمور التي كانت مسلم بها، على سبيل المثال مبدأ بيع الطاقة بأسعار مغايرة لسعر السوق، أو انكشاف المواقف والتموضوع الحقيقي لكثير من الدول، والتي كانت تتوارى خلف غطاء الديبلوماسية، ووجدت نفسها مرفوع عنها ذلك الغطاء بين ليلة وضحاها.
– ترسيخ الإجراءات الاقتصادية الروسية والترتيبات التي اتخذت أيضا على الصعيد الدولي، مثل اعتماد عملات أخرى بما فيها الروبل في التعملات التجارية الدولية، ما سينهي زمن سيطرة الدولار، واعتماد اتفاقيات بديلة لكثير من السائد في العلاقات المالية والتجارية الدولة كنظام سويفت مثلا. وإعطاء دور أكبر لمؤسسات مالية وتنموية غير البنك الدولي وصندوق النقد الذين رزح العالم تحت سيطرتهما لعقود طويلة، واليوم تصعد للواجهة مؤسسات مثل بنك التنمية لمنظمة شنغهاي والذي يفوق برأسماله رأسمال البنك الدولي.
ذلك كله، وبرغم مافي هذا الكلام من إرباكٍ على المستوى الإنساني في ظاهره، يدفعنا للاعتقاد بأن ضمان إحداث التحولات العميقة في الاٍقتصاد والسياسة الدوليين، من أجل ولادة جيدة لعالم جديد، يحتاج لحرب طويلة.