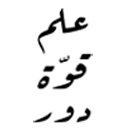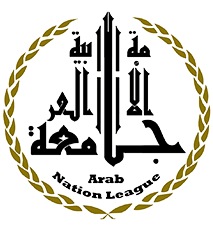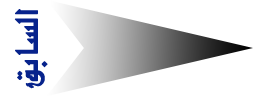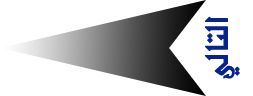لطالما كان تراث الأمم ركيزة أساسية من ركائز هويتها الثقافية، وعنوان اعتزازها بذاتيتها الحضارية في تاريخها وحاضرها؛ ولطالما كان التراث الثقافي للأمم منبعا للإلهام ومصدرًا حيويا للإبداع المعاصر ينهل منه فنانوها وأدباؤها وشعراؤها، كما مفكروها وفلاسفتها لتأخذ الإبداعات الجديدة موقعها في خارطة التراث الثقافي، وتتحول هي ذاتها تراثا يربط حاضر الأمة بماضيها، ويعزز حضورها في الساحة الثقافية العالمية. وليس التراث الثقافي معالم وصروحا وآثارًا فحسب، بل هو أيضا كل ما يؤثر عن أمة من تعبير غير مادي، من فولكلو، وأغان وموسيقى شعبية وحكايات ومعارف تقليدية تتوارثها الأمة عبر أجيال وعصو، وكذا تلك الصروح المعمارية المتعددة والمختلفة، وتلك البقايا المادية من أوانٍ وحلي، وملابس، ووثائق، وكتابات جدارية وغيرها؛ إذْ كلها تعبّر عن روحها، ونبض حياتها وثقافتها.
إن التراث هو تراكم خبرة الإنسان في حواره مع الطبيعة، وحوار الإنسان مع الطبيعة إذْ يعني التجربة المتبادلة بين الإنسان ومحيطه، وهذا المحيط الذي يضم حتى الإنسان الآخر فرداً كان أم جماعة·التراث يعني كل مفهوم يتعلق بتاريخ الإنسان في تجارب ماضيه، وعيشه في حاضره، وإطلالته على مستقبله· أما التراث الحضاري والثقافي فهي الممتلكات والكنوز التي تركها الأولون،حيث هي السند المادي واللاّمادي للأمم والشعوب؛ من خلالها تستمدّ جذورها وأصالتها، لتضيف لها لبنات أخرى في مسيرتها الحضارية، لتحافظ على هويتها وأصالتها.
التراث.. الذاكرة والبوّابة على العالم
لا شكّ أن التراث يمثّل الذّاكرة الحيّة للفرد وللمجتمع، ويمثّل بالتالي هويّةً يتعرّف بها الناس على شعْبٍ من الشعوب؛ كما أن التراث بقيمه الثقافية،والاجتماعية يكون مصدرا تربويا، وعلميا، وفنيا، وثقافيا، واجتماعيا..ذلكم أن تراكم الخبرات يُكوّن الحضارة، وتراكم المعلومات يُكوّن الذاكرة، وهذه الذاكرة بدورها وكما تقول: الباحثة تمبل كريستين في كتابها (مدخل إلى دراسة السيكولوجيا والسلوك):
« … هي التي تمكّننا من فهْم العالم، بأن تربط بين خبرتنا الراهنة، ومعارفنا السابقة عن العالم وكيف يعمل. » ولهذه الذاكرة كما للتراث الثقافي الذي ننادي بالحفاظ عليه علاقةٌ طردية مع الإبداع لدى الأفراد والمجتمعات. حيث أن لكل شعب موروثاته الخاصة به، والتي توارثها شفهيا، أو عمليا، أوعن طريق المحاكاة .. ليكون بمثابة فنون نتجت عن التفاعل ما بين الأفراد والجماعة، والبيئة المحيطة خلال الأزمان الماضية، ومع مرور الزمن تحولت إلى إنتاجٍ جماعي يختزن خبرات الأفراد والجماعات،وبقدْر ما هو مخْيالٌ للجماعة فإنه جدارٌ متينٌ لحفْظ هويّتها، ومحرّكٌ لها في الاستمرارية والوجود.
إن فقدان التراث الثقافي يعني فقدان الذاكرة..إن الذاكرة هي التي تساعد على اتخاذ القرا، فالفرد الفاقد ذاكرته لا يستطيع أن يستدلّ على باب بيته، فكيف والحال هكذا أن يصنع مستقبله، ويطوّر ذاته، ومثلما ينطبق هذا على الفرد ينطبق على الشعوب .إن التراث الثقافي وكما هو معروف لدى الباحثين،والمختصين يحتوي على جانبيْن :
1 ـ أوّلهما الملموس المادّي ممّا أنتجه السابقون من مبانٍ، ومدنٍ، وأدواتٍ، وملابس وغيرها.
2 ـ وثانيهما التراث الغير الملموس من معتقدات، وعادات، وتقاليد، وطقوس، ولُغات وغيرها وهو ما يُطلق عليه الموروث الشعبي.. فالحفاظ على هذيْن العنصريْن هو حفاظٌ على هويّة الأمّة وذاكرتها .. ويعني أيضا الحفاظ على المنتجات التي نستطيع من خلالها أن نقيس مستوى الحضارة لهذه الأمة أو تلك.
مكوّنات التراث الثقافي:
يشمل التراث عادة عدة أنواع وتصنيفات منها :
- التراث الشفوي: ويضم الروايات والحكايات،الأمثال والألغا. والشعر العامي أو الملحون. والموسيقى:(أندلسية، شعبية، صحراوية، سطايفية، رايوية، أمازيغية…). رقص شعبي:بكلّ أنواعه.
- التراث المكتوب: وثائق، مخطوطات.مكتبات قديمة. نصوص تاريخية ،رسوم على الكهوف ……
- التراث المبني:المدن العتيقة. الأحياء العتيقة التاريخية. القصو.القصبات .المساجد.الزوايا.الأبواب. الزخارف والنقوش.
- التراث المنقول: قطع أثرية كالنقود، والحلي، والأواني الخزفية، والأسلحة القديمة،وسائل شخصية لعظماء تاريخيين، وغيرها من الأدوات المنزلية، والفلاحية، والحرفية و قد نجدها محفوظة في المتاحف
- المواقع الأركيولوجية:مواقع أثرية قديمة منها:( التاسيلي .تيمقاد .جميلة …)
ينحدر التراث الجزائري من امتزاج عدة روافد منها : الأمازيغي. العربي الإسلامي،الأندلسي، الصحراوي، الإفريقي، التارقي …
مفهوم التراث الثقافي رحْبٌ
وإنّ كان البعض من الباحثين في هذا الحقل الثقافي يذهب إلى أبْعد من ذلك، إذْ يرى أن التراث الثقافي أرْحبُ من أن يُحصر في هذيْن العنصريْن؛ فلو أخذنا على سبيل المثال الموروث الشعبي كجزء مهمٍّ من التراث الثقافي، فإن هذا الموروث يشكل عالمًا رحبًا من الذاكرة الجزائرية، والذاكرة العربية لكونه يتكوّن من عالم متشابك من الموروث الحضاري، والبقايا السلوكية، والقولية التي بقيت عبْر التاريخ،وعبْر الانتقال من بيئة إلى أخرى، ومن مكانٍ إلى آخر..وهي سلوكاتٌ، وأقوالٌ راسخةٌ إلى يوم الناس هذا في العقل والضمير العربييْن بخاصة،ولا تُستثنى دولةٌ عربية في هذا.وأيضا يضمّ البقايا الأسطورية،أو الموروث المثيولوجي العربي القديم، كما يضمّ الفولكلورَ العربيَ في البيئات العربية المختلفة سواء أكان الفولكلورَ القوليَّ، أو الفولكلورَ النفعي، أو الفولكلورَ الممارسَ، وسواء ظلّ على لغته الفصحى، أو تحوّل إلى العاميات المختلفة السائدة في كلّ بيئة من هذه البيئات؛ حيث يذهب الكاتب السوري الدكتور أحمد زياد محبك إلى أبعد من ذلك فيرى:
« إن التراث الشعبي إبداع عفوي أصيل، يحمل ملامح الشعب، ويحفظ سماته، ويؤكد عراقته، ويعبر عن همومه اليومية، ومعاناة أفراده، على مختلف مستوياتهم، وهو صورة لروحهم العامة، وشعورهم المشترك.»
في مفهوم الهويّة
( الهوية ) مأخوذة من ” هو ” بمعنى جوهر الشيء وحقيقته ..إنها كالبصمة للإنسان يتميز بها عن غيره. وتُعرّفُ الهوية أيضا بمعنى ” التفرّد “، فالهوية الثقافية تعني التفرّد الثقافي بكل ما يتضمنه معنى الثقافة من عادات وأنماط سلوكٍ، وميلٍ، وقيمٍ، ونظرةٍ إلى الكون والحياة.
إن مفهوم ” الهوية ” لا يجب أن يؤخذ بالبساطة العفْوية، إذْ لا يزال يلفّه الكثير من الغموض، فهناك من المفكرين مَنْ يصل به الأمر إلى حدّ القول بأن الهوية لا وجود لها أصلا، ذلك أن الهوية الشخصية تُـفترضُ أن يبقى الإنسان نفسه على مرّ الزمن..أمّا الهوية الجماعية فهي أكثر إشكالية ..الهوية الجماعية تفترض(التماثل التام) في الـ :(نحن) الجماعية، بينما البشر مختلفون تبعا لطبيعة الظروف التي تكوّنوا في إطارها، وتبعا للبيئة التي يحيوْن فيها ومكوّناتها الحضارية والثقافية والاجتماعية ، وهذا ما عبّر عنه الفيلسوف الفرنسي ” ديول ريكور ” بالقول:« … إن أهواء الهوية متجذّرة فينا بعمق، وليس هناك أي شعب يعاني منها أكثر من شعب آخر.»
الهوية الثقافية، هي تعبير عن الحاجة إلى الاعتراف والقبول والتقدير للإنسان كما هو في تفرده وتميزه. ففي الهوية الثقافية تشتغل جدلية الذات والآخر وتعيد كل جماعة بشرية تأويل ثقافتها من خلال اتصالاتها الثقافية، أو قد تنزع نحو المثاقفة- وما يشبهها.. وهي كذلك كائن جماعي حي يتحول ويتغير من الداخل على ضوء تغير المصادر القيمية والسلوكيات، ومن الخارج بفعل أشكال التأثير الخارجي الناتج عن علاقة الفرد بالمحيط.. وأيضا “كيان يصير، يتطو، وليست معطى جاهزا ونهائيا. وهي تصير وتتطو، إما في اتجاه الانكماش وإما في اتجاه الانتشار، وهي تغتني بتجارب أهلها ومعاناتهم، بانتصاراتهم وتطلعاتهم، وأيضا باحتكاكها سلبا وإيجابا مع الهويات الثقافية الأخرى التي تدخل معها في تغاير من نوع ما “، بتعبير د.عابد الجابري.
إنها الحد المكتسب من المعارف والتصورات والممارسات الفكرية لدى الإنسان في محيطه الاجتماعي، والتي تلقاها لمصلحته ومصلحة هذا المحيط..والهوية الثقافية والحضارية لأمة من الأمم، هي القدر الثابت والجوهري والمشترك من السمات والقسمات العامة، التي تميز حضارة هذه الأمة عن غيرها من الحضارات والتي تجعل للشخصية الوطنية أو القومية طابعا تتميز به عن الشخصيات الوطنية والقومية الأخرى..
وفقا للعديد من الدراسات السوسيولوجية، والأنتربولوجية التي تتفق على كون الهوية تُــعدُّ معطى اجتماعيا يقوم على مبدإ التطابق والانسجام، ويحمل دلالات التنوع والتكامل والاختلاف، فإن الهوية تشتغل في التراث الثقافي كشرط وكمناخ؛ فهي سند الإبداع، وشرط الإحساس بالذات والانتماء، بل هي التعبير الصادق عن الذات في أقصى درجات انتشائها واحتفالها، هي بذلك تغدو منطلقا وطريقا وهدفا.. إنها ترتكز على شعور غريزي بالانتماء والمحلية وتظهر ملازمة للثقافة الخاصة في حدود ملامحها الأصلية والأهلية التي تشكل حاملا للهوية الجماعية، أي الهوية القائمة على الإرث الثقافي والسلالة المشتركة (غيرتس 1963).. ومن ثم، فهي تساعد على اكتشاف النسق البنياني للمجتمع حتى يتحول إلى كل منسجم على مستوى الوعي..
إن الشعوب تتعامل بأشكال مختلفة مع تراثها،أي أنها تتعامل مع تراثها طبقاً لبُناها المعرفية، وانطلاقاً من أحكامها ومفاهيمها. لذلك يجيء التعامل مختلفاً. ما نريد أن نقولـه هنا هو أن الاختلاف في مسألة التعامل مع التراث ليس فطرياً، بل أنه ذهني ولـه ما يفسره في طرائق التفكير والانفعال عند كل مجتمع من المجتمعات، وهذا الاختلاف واضحٌ بين الشعوب الغربية وغيرها من الشعوب الأخرى.
الحاضر بوّابة الإنسان الغربي للإطلالة على الماضي
فالإنسان الغربي يدخل إلى إرثه الثقافي في باب الحاضر،لا من باب الماضي، وهذا الموقف المعرفي شديد الأهمية لفهم كيفية الفهم عند الغربي، ولتمييزه عما هو جارٍ عند سواه من الحضارات القائمة اليوم؛ إذ عندما يلتفت الغربي إلى الماضي، ينقطع معرفياً عنه مع إبقائه على روابط التواصل الثقافية معه..يعني أن موقف الغربي من تراثه يخضع لعملية فصْل بين ما هو ثقافي وما هو تاريخي، فما هو ثقافي، أي إنساني وأممي، يبدي تعلقه به ؛أمّـا ما هو تاريخي بمعنى أنه ينتمي إلى أشكال من التفكير والعمل مطابقة لنماذج الماضي، فالغربي يتعامل معها ببرودة وعقل نقدي. وليس معنى هذا أن الغرب لا يُولي أهمّية للتراث، كلاّ فاهتمام الغربيين بالتراث سيّما المادي منه هو من الأولويات ذلك أن أغلب الدول الغربية خاصة الأوروبية منها يشكّل التراث المادي لديها كنوزا نادرة تعتزّ بها، وتحافظ عليها وتوظفها لفائدة المواطن وكمورد اقتصادي مهمّ جدا من ناحية أخرى كفرنسا ،وإسبانيا،وإيطاليا على سبيل المثال لا الحصر .ففي هذا الشأن يقول الدكتور فريدريك معتوق في كتابه” مدخل إلى سوسيولوجيا التراث ” الذي صدر في طبعته الأولى سنة 2004 ، وفي طبعته الثانية سنة2010 ما يلي:
« ويصل فيما بعد الكتاب ليقول إن الغربي يدخل إلى إرثه الثقافي من باب الحاضر، لا إلى حاضره من باب الماضي. وهذا موقف معرفي هام ومتميز عما هو عند سواه من حضارات أخرى وهذا يعني أن موقف الغربي من تراثه يخضع لعملية فصْل بين ما هو ثقافي وما هو تاريخي.»
ففي المدة الأخيرة تصاعد الاهتمام العلمي الأكاديمي والسوسيوثقافي بقضية التراث عامة في هذه البلدان على أساس أنه تراثٌ عالمي، وبغضّ النظر من صدمة العولمة التي سعت إلى سحْق الهويّات الأخرى وفرض مقولة: ” نهاية التاريخ “، إلاّ أن هناك رؤية أخرى أخذت مكانها في الغرب أخيرا مؤدّاها أنه لمّا كان التراث العالمي في مُجمله خاصة ما صنّفته منظمة اليونيسكو مكسبا هامًّا ” تتقاطع فيه مصالح الشعوب والأمم، وأفكارهم،ورؤاهم، ومطامحهم فقد أصبح موضوعا مشتركا في صُنعه وإنتاجه ؛ وكذلك في البحث فيه،بحيث يكون إحدى مرجعياتهم في كفاحهم من أجل حياة مشتركة قائمة على الاحترام، والندّية، وإعادة بناء العالم بما يخدم الجميع.”
التراث الثقافي جزْءٌ من حاضرنا
بينما يتعامل أبناء بلدان الجنوب بما في ذلك الشعوب العربية مع مسألة التراث على أساس لا يفصل فيه الفرد بين الماضي والحاضر. فالقطيعة مع التراث غير واردة بالمعنى الغربي للكلمة. يُستمد هذا التواصل بين ما عيش في السابق، وما يُـعاش اليوم ،بحيث تبقى مفاهيم التراث ومفاهيم المعاصرة تنتمي كلها إلى بنية واحدة، يسودها فهْمٌ واحدٌ، وممارساتٌ قد لا تختلف عن بعضها كثيرا. وهذا ما ينطبق عليه ما نعته الأميركي توماس كوهن بالتفكير الدائري.
إذْ يتّضح لنا أن بلدان الجنوب تتعامل مع تراثها الفكري والثقافي اليوم على أساس أنه:
1 ـ جزء لا يتجزأ من الحاضر، فالتواصل الزمني ما بين ما قيل، أو رُسم، أو كتب أونُحت، أو بُني في الماضي، وبين ما هو قائم أمام أعين الفرد اليوم هو تواصلٌ معرفيٌّ يتجسد في اعتماد راهنٍ لأشكال في التعبير والممارسة تتطابق مع تلك التي كانت معتمدة إذاك.
2 ـ جزء من الوعي الاجتماعي والسياسي، ذلك أن الفرد في علاقته مع التراث لا يقيم قطعاً بينه وبين مواده، معتبراً أن ما صحّ من مقولات، ونماذج الأزمنة الماضية يصلح أيضاً للاهتداء اليوم على المستويين الاجتماعي والسياسي.(إشكالية الأصالة والمعاصرة).
3 ـ يشكل نموذجاً مثالياً أعلى: فالتراث لتطابقه مع مبادئ الحياة الاجتماعية، والسياسية المعاصرة من حيث انتماء الاثنين إلى فضاء التقليد خاصة في العالم العربي؛ يجسد مرجعية عليا لا تقبل المناقشة، أو المعارضة أو المساءلة. فالتراث هنا يشبه المُثل العليا الأفلاطونية التي لا يحق للإنسان سوى الاهتداء غير المشروط بها، لنورانيتها.
4 ـ يحج إليه الناس، فالتراث الموضوع على هذه المرتبة الرمزية العالية يضْحى فوق الناس ومصدر جذب لهم. والتعبير عن هذا الموقف العام يتم لا بزيارته مع البقاء خارجه، بل بالحج إليه بكل الشحْـن العاطفي والمعنوي الممكن؛ ذلك أن التراث يتحول في هذا السياق إلى إطار لتأكيد العقائد.
5 ـ يشكل دعوة مفتوحة للعودة إلى الينابيع؛ فالتراث، في المجتمع التقليدي، هو الخزان الحي لتجليات الفكر والأدب والعلم للعصر الذهبي الزائل. فهو أقوى من الحاضر من حيث أن هذا الأخير لم يتمخض بعد عن تصميمات أو نماذج أرقى من نماذجه. فالعودة إلى التراث تغدو لذلك لازمة النهج التقليدي في المسلك الحياتي الذي لم يتمكن من تخطي ما أنجز في الماضي ولا يرغب راهناً في تخطيه. فالحضن الدافئ للتراث مطمئن وسهل المنال وأرقى من الحاضر في هذه المعادلة.
التراث..هويّة متجذّرة في اللاّشعور:
علاقة الإنسان العربي بتراثه علاقة عضوية حيث أن هويته القومية برمتها تتغذى من التراث، لارتباطه في وعيه بأبعاد حضارية وتاريخية ودينية وسياسية على حد سواء. فتعلقه بما يختزنه ماضيه من إنجازات عملية وفلسفية وأدبية أشد من تعلق أي إنسان آخر بتراثه شرقاً وغرباً.
إن الإنسان العربي ينتمي انتماء كليًّا إلى تراثه، ويتماهى فيه معنويًّا دون تحفّظٍ، حيث يشعر بأن تعلّقه به هو امتدادٌ لتعلّقه بتصوّره للدنيا والكون،وحتّى لِــما بعد الحياة، فيتخذ التراث بُعْدا روحانيا ونفسيا ممّا يضعه خارج دائرة التفكير، وداخل دائرة التقليد، فالمساس بالتراث غير وارد عنده،وكذلك مساءلته..إذ هذا التراث قيمة عليا عنده يتعامل معها بشكل مثالي؛ لكن هذه المثالية تبدأ بتجميد هذا التراث. في هذا المضمار يقول الدكتور فريدريك معتوق في كتابه المشار إليه أعلاه:
«… فعلاقة العربي بتراثه “علاقة عضوية حيث أن هويته القومية برمّتها تتغذى من التراث، لارتباطه في وعيه بأبعاد حضارية وتاريخية ودينية وسياسية على حد سواء. فتعلقه بما يختزنه ماضيه من انجازات علمية، وفلسفية، وفكرية، وأدبية أشد من تعلق أي إنسان آخر بتراثه شرقا وغربا. من الممكن أن تبتر الإنسان الإفريقي، أو الأسيوي عن تراثه، دون أن يموت حضاريا. أما العربي إنْ قطعته عن تراثه، حكمت عليه بالموت؛ ذلك أن للتراث عند الإنسان العربي مدلولا دينيا، اجتماعيا وعصبيا. حياته المعاصرة مبنية على هذه المعادلة الموروثة والمعيشة في آن”.
الدكتور المرحوم محمد عابد الجابري في كتابه” نحن والتراث” يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يؤكد على أن الإنسان العربي بما في ذلك المثقف مؤطرٌ بتراثه الذي يحتويه احتواء كليا يُفقده استقلاليته، وحريته، فهذا الإنسان تلقّى ولا يزال يتلقّى تراثه منذ ميلاده ككلمات، ومفاهيم، كلغة وتفكير، كحكايات وخرافات وخيال، كطريقة في التعامل مع الأشياء، كأسلوب في التفكير، كمعارف وحقائق..كل ذلك بعيدا عن الروح النقدية، فهو عندما يفكر، يفكر بواسطة هذا التراث ومن خلاله، إذْ يستمدّ منه رؤاه واستشرافاته ممّا يجعل التفكير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون ” تذكّرًا..ولذلك فالجابري يرى حتى القارئ العربي عندما يقرأ نصّا من نصوص تراثه يقرأه متذكرًا، لا مكتشفًا، ولا مستفهمًا.
نستخلص ممّا أورده الجابري أن كل الشعوب في المعمورة ترتبط بتراثها بنسب معيّنة، وتفكّر به ومن خلاله، ولكن الفرق شاسعٌ بين من يفكر بتراثٍ ممتدٍّ إلى الحاضر، ويشكل الحاضر جزءا منه..إذْ هو تراث متجدّد يخضع باستمرارٍ للمراجعة والنقد، وبين منْ يفكّر بتراث توقّف عن التطوّر وانقطع عن ديناميكية الحياة في كل أبعادها منذ قرون..تراث تفصله عن الحاضر مسافة حضارية طويلة.
إن هذه الخصائص من أهم العوامل المساعدة في دعْم العلاقات الإنسانية بين الشعوب. وقد اختلفت الدراسات، وتنوعت الاتجاهات في طرائق تناول هذا العلم نتيجة للظروف التاريخية التي مرّ بها هذا التراث مع تأكيدها أهمية دراسته انطلاقاً من جملة اعتبارات مثل: إن الاستناد للتراث ونتائج الأسلاف يُـعدُّ ضمانة لاستمرارية وجود الأمة بهويتها، وخصوصيتها المميزة، وأن هذا يحقق التوازن في معادلة (الماضي الحاضر المستقبل)، كما يعد التراث الثقافي بكل مكوّناته وزُخْـمه، أحدَ العناصر الأساسية لمقومات أي أمة لاحتوائه خلاصة تجاربها وخبراتها التراكمية، وأن الانتهال من تجارب الأسلاف يعني تجدد الأفكار الملهمة للأجيال القادمة، وأن الاتصال والتواصل بماضي الأمة، وروحها المتجلية في نتاجها يعزز الاندفاع الايجابي الذي تتطلبه الحياة المعاصرة ويضمن في الوقت نفسه، التوازن لتفاعل عطاء وفكر الأمة مع العطاء والفكر العالمي المعاصر، فلا اقتباس لحد الذوبان، ولا انغلاق لحد الوقوع في الذاتية الضيقة.
الموروث الثقافي ضمانةٌ لاستمرارية الكينونة
وإذا كان التمسك بالموروث ضمانة حقيقة لاستمرار وجود الأمة بهويتها وخصوصيتها، فإن الأمة العربية أحوج من غيرها لممارسة هذا الفعل، خاصة في ظل ما تواجهه الذات العربية والهوية القومية للأمة من تحديات بغية تذويب الذات وتشتيتها، فتمسكها بالموروث القومي بمأثوراته الشعبية مطلب ملحٌّ للدفاع والحفاظ على هذه الذات؛ إلا أن تراثنا الثقافي لا يزال يعاني من الإهمال، وعدم الالتفات الواعي بالدراسة، والتفحص للتعرف على الأسس التي قامت عليها أمتنا العربية، بالرغم من أنه يشكل وحدة متماسكة في الأسس العامة التي بني عليها وفي الطرق التي يؤدي بها، وفي مضمونه أيضاً من حيث المعنى والأهداف.
وإذا كان البعض من المثقفين العرب اختلفوا، ولم يتفقوا بشأن معظم الثنائيات المتداولة في الفكر العربي، فإنهم اتفقوا في المعظم على سبيل المثال أن الموروث الشعبي العربي لا يحمل أية قيمة إنسانية وحضارية تستدعي التوقف عندها ودراسة عوامل تكونها، كما اعتبروه خالياً من أية قيمة فنية، أو جمالية أو أدبية، فأغفلوا بذلك قيمته كمصدر من مصادر ثقافتهم ونتاجهم الفكري والأدبي، بل راح بعضهم إلى أبعد من ذلك في تعاليه، بوصف التراث الشعبي خطراً يجب التصدي له، والقضاء عليه وهو موقف تبناه معظم المثقفين العرب الحداثيين، وأنصار الثقافة الغربية، فربطوا بين الموروث الشعبي وبين كل مظاهر التخلف والرجعية والانحطاط التي شابت الحياة الفكرية في العالم العربي، كما اعتبروا أن ممارسة العادات، والتقاليد سلوك شائن مخالف لمنطق التطور العصري.
مِن هؤلاء أحد أعلام الثقافة العربية الدكتور لويس عوض إذْ في مقال طويل له بعنوان: الفولكلور والرجعية، نشره في صحيفة الأهرام المصرية أواخر الستينيات، وبالضبط في يوم: 21/11/1969 جاء هذا الموضوع ضمن مقالات أخرى في كتابه الذي عنونه بـ ” ثقافتنا في مفترق الطرق ” يقول الدكتور لويس عوض قبل ما ينيف عن الأربعين عامًا:
« … فقد كانت أكثر هذه البدع في زمانها، وفي سياقها التاريخي فنونا وآدابا شعبية حقًّا؛ أمّا اليوم فهي مجرّد بدع لأنها خرجت من عصرها، ومن سياقها التاريخي، وفقدت معناها، في عصرنا، عصر غزْو الفضاء، ولا أحْسبُ أنها شكلاً ومضمونًا قادرة على التعبير عن الإنسان الحديث في الدول النامية، بل لا أحسب أن فيها ـ باستثناءات قليلة ـ خامات فعْلاً يمكن للفنان، أو الأديب، أو المثقف شعبيا كان، أو برجوازيا أن يستخرجها، ويجدد فيها الحياة بما يتلاءم مع روح العصر الحديث.»
وهذا علمٌ آخر من أعلام الثقافة العربية المعاصرة، وشيخ المؤرخين الدكتور أبو القاسم سعد الله ـ أطال الله في عمره ـ يقول في تصديره لكتاب: الشعر الشعبي الجزائري.. من الإصلاح إلى الثورة، الذي ألّـفه الدكتور أحمد زغب، وتكفّلت بطبعه الرابطة الولائية للفكر والإبداع، ودار الثقافة بالوادي سنة 2009 يقول الدكتور أبو القاسم سعد الله في تصديره الذي أرّخه في: 03/09/2008 :
« بيني وبين ما يُسمّى بالأدب الشعبي علاقة غير ودية، فهو عندي علامة على جهْل أصحابه، وأميتهم يلجؤون إليه بدل الأدب الراقي الجميل للتعبير عن خلجات نفوسهم، ومشاعرهم؛ أمّا المثقف عندي فيرتفع عن الأدب السوقي، أو العامّي؛ كما يرتفع في حياته، وآدابه، ودروسه، ومؤلفاته عن الكتابة، أو الحديث بلغة العامة؛ لأن ذلك ينحدر بمستواه الثقافي، وربّما الأخلاقي والاجتماعي أيضًا فيصبح في نظر المثقفين عاجزًا عن أداء أفكاره بلغة راقية تحتوي على عناصر الفن الأصيل، والجمال الأدبي الذي يرفع صاحبه إلى مصافّ الفحول والمبدعين، ويبوّئـه المكانة المكانة التي يستحقّها والتي هي الإسهام في تربية المجتمع، وترهيف الذوق، وخدمة اللغة. ومن أجل ذلك لا أحترم الأديب المثقف الذي يدّعي أنه يكتب بالفصيح والملحون ( أو النبطي عند بعض أهل الخليج ).
تراثنا الثقافي ليس مظهرا متحفيا
واليوم في ظل المبادئ العلمية الحديثة التي بدأت تعي أهمية التراث الثقافي بكل مكوّناته، وتدرك هذه القيمة الإبداعية والجمالية في الثقافة الإنسانية، والدور الذي يلعبه في تشكيل المقومات الأساسية لهذه الثقافة، فإن التراث الثقافي الجزائري أحوج من غيره لمثل هذه الدراسات التي تأخرت كثيراً، وهذه مهمة الدارسين والمهتمين بأن يعلنوا أن هذا التراث الغني والمتواجد في كل ربوع الجزائر بمرافق مختلفة، وبصور متنوعة لهو من الغنى التاريخي، والهويّاتي، والجمالي ما يجعله ليس قضية متحفية، أو مجالا للدراسات الأكاديمية وحسب، يتم التعامل معها كمتعة خالصة، أو كفرجة في أوقات الفراغ.
تكمن أهمية الحفاظ على التراث الثقافي في الأهداف التي يمثلها هذا التراث وهي:
1 – الحفاظ على التراث الثقافي وبعده الحضاري، وحفظه لذاكرة وهوية الإنسان والمجتمع.؛ ذلك أن الإنسان مكوّن من مادة وروح..وبما أن التراث الثقافي يحتوي على جانبين: الملموس ممّا أنتجه السابقون من مبانٍ، وأدوات ومدن وملابس، وغيرها ممّا هو مادي، وغير الملموس من معتقدات، وعادات، ولغات، وتقاليد وغيرها؛ فإن هذيْن العنصريْن يكوّنان عصب الحضارة، فالحفاظ عليهما يعني الحفاظ على ما أنتجه الإنسان في مجتمع ما ككينونة وكهوية فردية ومجتمعية..فالتراث يمثل الذاكرة الحية للفرد وللمجتمع، ويمثل بالتالي هوية يتعرف بها الناس على شعب من الشعوب، فحضيرة التاسيلي، أو الأهقار تمثل هوية الإنسان الجزائري في أقصى الجنوب الجزائري.
2 ـ الحفاظ على التراث الثقافي هو إغناءٌ للثقافة الإنسانية بالحفاظ على التنوع الثقافي لدى شعوب المعمورة.
3 ـ إن التراث بقيمه الثقافية والاجتماعية يكون مصدرا تربويا، وعلميا، وفنيا، وثقافيا، واجتماعيًا.
4 ـ إن فقدان التراث الثقافي يعني فقدان الذاكرة، ويعني افتقارا اقتصاديا مهمّا في التنمية المحلية لمناطق هذا التراث، وخلْق ديناميكية تنموية شاملة يستفيد منها السكان المحليون، وخزينة الدولة من موارد مالية هامة بالعملة الصعبة، والعملة المحلية.
كـلّ الأمم تعـتـزّ بتراثها
إن لكل أمة تراثا تعتز به وتفتخ، وتعتبره الجذر الذي يمتد في الماضي السحيق ليؤرخ ماضي الأمة وأمجادها العظيمة، وتعتبر الحاضر امتدادا للماضي، ويشكل السمة المميزة لكل أمة عن غيرها. ويتضمن الموروث التراثي الثقافي على معلومات جمالية، وتاريخية، وعلمية، واجتماعية اقتصادية، أو قيم روحية للماضي، والحاضر والمستقبل. وتبرز هنا الحاجة الماسة والمستمرة لتقييم أهمية وحالة التراث الثقافي، والدور الذي يلعبه في وجوده على هذه الأرض، والدور الاقتصادي والتكنولوجي للتراث الثقافي في الفنون ، والتغيرات الاجتماعية والعلمية. وهذا التقييم يعتبر أساسا لاتخاذ القرارات من أجل حماية ونقل معاني القيم التراثية للمجتمع.
وهذه الحماية لن تتحقق إذا لم تكن ضمْن نهضة ثقافية حديثة شاملة، مرفقة بوعي لمكوّنات هذا التراث الثقافي، والنظر إليه لا كماضٍ غاب وانقضى، بل هو حاضرٌ دوْمًا وحيٌّ، ومحفّزٌ لنا في الاندماج بفعالية في الحاضر، والإطلالة بثقة على المستقبل، لا كقيدٍ يكبّلنا ويشدّنا إلى ذلكم الماضي لوحده، فننقطع عن دورة الحياة المعاصرة، وننكفئ على أنفسنا فتجرفنا التيارات الخارجية، ولا نقوى حينها على المقاومة.
نشرت في مقالات مصنف التكامل أضف تعليقا
الثقافة والتراث
نشر في 24/11/2015
إذا كان لكل أمة تراث تعتز به وترجع إليه ، فإن تراث أمتنا العربية عميق الجذور ، فهو يرتبط في منبعه بالأصالة وفي امتداده بالرواية ، وهو بذلك من أهم مصادر ثقافتنا .
ويشكل المد الثقافي عندنا أهمية بارزة في الهوّية العربية بحكم أنها تستمد جذورها عبر قرون طويلة من تاريخ الأمة العربية مما يدفعها للمحافظة على جذورها الممتدة في أعماق تاريخها المرتبطة بمفرداتها وعناصرها المتجذرة في أصولها ، المواكبة لمكانتها بين الأمم التي تستلهم ماضيها المشرق ولا تنسى حاضرها المؤسف ، وتتطلع إلى مستقبل أفضل من الحاضر ، يواكب طموحات الأجيال المتطلعة إلى حياة أفضل ومجال أرحب في مجال ثقافة أوسع على مستوى التقدم الباهر في هذا العصر .
ولا يعني الاهتمام بمسايرة العصر أن ندير ظهورنا لماضينا العلمي والفكري ونلهث وراء كل جديد معاصر ، ولو أنه لا يحقق لنا نتيجة ولا يضيف إلى ثقافتنا ما يفيد ، فليس المهم الركض خلف كل مستحدث لحداثته ، حتى لو لم يكن وراءه جدوى ، وإنما الأهم الأخذ من القديم أو الحديث بقدر ما يضيف إلى رصيدنا الفكري ما يدعمه ، وإلى مجالنا العلمي ما يعزره .
ومن الملاحظ في مسارنا العصري أننا نجد متابعة تقليدية لكل ما يصدر عن الأجنبي ، ولو كان لا يلتقي مع توجهاتنا ولا يزيد رصيدنا ، وأبرز هذه المتابعات ما نلمسه في التحولات الفكرية والمسارات الثقافية ، وقد تنطوي تلك التحولات على شطحات ، ربما امتدت إلى ماله مساس بثوابتنا وجور على قيمنا ، والسبب في ذلك يكمن في ازدراء بعضنا لتراثنا وتجاهل أصولنا وموروثاتنا ، والتطلع إلى ما لدى الغرب، ولو كان من مخلفات الماضي السحيق مما يرجع إلى تراث اليونان والرومان ، فما نقل إلينا من مواريث تلك الأمم البائدة فهو المستحسن في نظر المبهورين منا بما يصدره الغرب إلينا مما يعده من مقومات تراثه ، وما يتصل بتراثنا فإنه لا يستثير نخوتنا العربية للاهتمام به والتعرف عليه، وذلك يتمثل في الانقياد غير المبرر لكل ما يصدر عن الأمم الغربية ، حتى لو كان مخالفـًا لمفاهيمنا ومختلفـًا مع أصالة تراثنا ، على الرغم من توافر الإبداع فيما خلفه أسلافنا من فنون القول ومجالات العلوم والآداب.
إلا أن بعض المنظّرين من المفكرين العرب المحدثين نسي مآثر الأسلاف في حماسة التلقي عما يصـدر عن الغرب ، ومن أولئك المنظرين من أنكر أن يكون في أدبنا روايات طويلة أو قصص قصيرة ، وأن هذا اللون من الآداب لم يكن له أي ظلال في تراثنا ، ولم تعرف آدابنا إلا ما أخذناه من أدباء غربيين ابتكروا هذا الإنتاج وأبدعوا فيه، ومرد هذا التصور إلى الزهد في الاطلاع على المراجع التراثية في ثقافتنا، ولو أن الذين قالوا بتجريد تراثنا من جميع الفنون المستحدثة التفتوا إلى هذا التراث – كما التفت الغربيون إلى تراث من قبلهم – ومنحوه بعض اهتمامهم لوجدوا أن أسلافنا قد سبقوا الغربيين إلى التنويع في العطاء الأدبي ، فابتكروا في مجال الرواية والقصة ووضعوا الإرهاصات لهذا الفن الأدبي ، حيث ملامح هذا الفن الروائي لدى أبي العلاء المعري في (رسالة الغفران) التي تأثر بها دانتي في روايته التي تماثل (رسالة الغفران) والتي سماها (الجحيم).. كما نجد الملمح الآخر في رواية “روبنسن كروز ” الذي ذكر كثيرون من كبار الكتاب أنها مقتبسة من ” حي بن يقظان ” لابن طفيل .. وتبدو ملامح القصة واضحة في مقامات بديع الزمان الهمداني ومقامات الحريري ، وإن جاء منحاهما لتأصيل اللغة العربية وإثراء مفرداتها ، فقد جاء على منوال الحكاية التي تمثل إرهاصـًا لبناء القصة وتأصيلها في بداية تكوينها الفني .
ومن قبل ذلك حفل الشعر العربي منذ استهلاله في العصر الجاهلي ـ وعلى امتداد العصور التالية له ـ بملامح هذا اللون القصصي ، فلماذا نتنكر لماضينا ، ونتجاهل تلك الملامح ؟ !! فإنها مهما كانت خافتة في البداية فهي تمثل بوادر مبكرة في عالم الرواية والقصة – ؟!
فهل من مقتضى الانبهار بالطفرة الحضارية هو أن يهون تراثنا علينا الذي انصرفنا عنه تحت وطأة التهوين منه والتهويل لتراث الآخرين ؟!
وذلك ما دعا إلى وضع حاجز نفسي بيننا وبين رؤيتنا الواقعية لتراثنا الثقافي ، وإذا كانت هذه نظرة بعضنا إلى هذا التراث في ظل الانبهار بتراث الآخرين ، فقد استطاع صوت أسلافنا أن يعبر القرون ، وأن يحمله الأثير المتجدد إلى العالم في شكل عطاء علمي وثقافي ، وقد كان ذلك التراث بمثابة غذاء فكري وعطاء تنويري .
وإذا كان من المفيد أن ننفتح على الثقافات الأخرى جميعها على مختلف أنواعها على أساس أن المعرفة العلمية والثقافة بمفهومها العام قاسم مشترك للبشرية يستفيد منها الجميع ، فإننا نجد الغربيين قد استفادوا من إنتاج علمائنا ومفكرينا ، فدرسوا مؤلفاتهم في بدايات النهضة المعاصرة واقتبسوا كثيرًا من الأفكار والدراسات، ونحن على هذا المنوال نسترد الدين فيما نأخذ عنهم دون إخلال بنسق الحياة عندنا، ودون أن يحجب ذلك رؤيتنا الصادقة لمآثر أسلافنا وأمجاد ماضينا .
ولو استطاع العرب أن يتجاوزوا ضعفهم ويتخلوا عن التفرق بينهم الذي يكرس هوانهم ، وأن يغيروا الصورة الهامشية التي رسمها الغرب لهم والتي يعيشونها في حاضرهم ، لكان بإمكانهم تجديد حيويتهم واستنهاض هممهم و استنفار طاقاتهم ، وبهذا التوجه الحيوي ينتظمون في ركب التقدم الذي تخلفوا عنه مسافات طويلة تقدمتهم مجموعات من الأمم المعاصرة بملايين الأميال ، وهم شبه نائمين استطابوا الكسل فقنعوا من الحياة بالعيش على هامشها ، واكتفوا من التقدم باستغلال وسائله دون المشاركة في العمل والإنتاج .
وواقع الحال هذا مخالف للدين الذي يأمرهم بالعمل ويدعوهم إلى اليقظة ويحفزهم للتقدم ، كما أن ذلك مضاد لنهج التراث الذي ورثوه عن أسلافنا السابقين الذين كانت لهم مناراتهم العلمية وحضارتهم الإسلامية .
وقد مضت تلك العصور الزاهية بما حققته من معرفة وما تركته من مآثر عليمة وآثار فكرية كانت محل اهتمام الأمم الغربية وموضع الاستفادة منها في نهضتها الحاضرة ، فقد جرى تدريس عدة كتب عربية في مدارس الغربيين بعد أن تُرجمت إلى لغاتهم ؛ لأنها تشتمل على علوم مهمة وثروة معرفية كانوا يفتقرون إليها في بداية نهضتهم ، وقد أصبحت تلك المؤلفات ركيزة لمنطلق الحضارة في بدايتها المبكرة ، فكانت أسماء بعض علمائنا معروفة لدى الغرب أكثر مما هي معروفة لدى بعض المنتسبين إلى الأمة العربية المزدرين لكل ما ينتسب إلى أسلافنا من علم وفكر ، وكأن قد كُتب على الأمة العربية الإسلامية في حاضرها أن تتجرد من ماضيها ، وهذه النظرة الجاحدة تعتبر وصمة عقوق من أبنائها المنتمين إليها بالنسبة المخالفين لها في الروح .
وذلك المخاض التاريخي الذي تولدت عنه نهضة معرفية عربية مما يؤكد أن تراثنا لا يقل عن أي تراث حضاري إذا وجد له سياج من أبنائه يحميه من الضياع ويصونه عن الابتذال ، فلا يليق بنا أن نظل في موقفنا الحائر نقرع باب العصر فلا يؤذن لنا بالدخول في معتركه ؛ لأننا أمة فرطت في ماضيها ولم تصنع حاضرها ، وبذلك فقدت وجودها في عصر يموج بالحركة السريعة ويزخر بالإنجازات الرائعة والقفزات الباهرة ، ولن نلحق بركب التطور إلا إذا عادت الأمة إلى رشدها فاستلهمت ماضيها العلمي وجددت تاريهخا الحضاري وتحولت إلى واقع جديد في التطلع إلى الأمام والمساهمة في دورة العصر ، فإنها بذلك تستطيع أن تُثبت وجودها وحيويتها وتحتفظ بمكانتها مع بقائها مستمسكة بهويتها .
والمجتمعات الغربية ـ مع تطورها السريع وإنجازها المتطور وتفوقها غير المحدود فإنها – على اختلاف لغاتها وتعدد شعوبها وتنوع اتجاهاتها – ما زالت تحافظ على التراث الذي ورثته عن حضارات سابقة بقيت لها شواهد مماثلة في المتاحف ومعالم بارزة في السياحة ، كما أنها ظلت محل الاهتمام الجماعي ممثلة في إصدارات حديثة وإخراج جديدة .
ويمكن لثقافتنا أن تتعايش مع الثقافات المعاصرة متى التفتنا إليها من خلال رؤية موضوعية ، فنأخذ ما يضيف إلى ثقافتنا ولا يجرح هويتنا ، مطلوب من الأمة أن تحافظ على عقيدتها من أن تذوب ففي أي تيار وتلتزم بقيمها من أن تبتذل اتباعـًا لأي تقليد ، وأن تحرص على إيقاظ ماضيها العلمي المتألق وتعمل على تجديد سجلها الحضاري والاندماج في العصر دون الوقوف على عتبة التاريخ أو الاكتفاء بالانزواء في عباءة الماضي ، ولن يرجع المجد الذي اندرس أو يعود الإشراق الذي أفل إلا بالتجاوب مع حركة العصر إلى جانب التمسك بالجذور ، فعلينا أن نرسم لنا هدفـًا نصل إليه ونشق طريقـًا يقودنا إلى المجد ، ونصنع واقعـًا يعلو بنا إلى واقع الأمم الراقية ، ويضعنا على مستوى الشعوب المتفوقة .